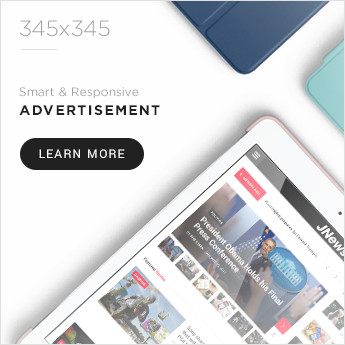هذا نص وفاء لجدي، الرايس سلامانكا، الذي علمني أن الأخلاق قد تكون أحيانا أبلغ من السياسة..
ليست كل سيرة تسجل بمداد، فكم من حياة كتبت بأثر الكف، لا بحرف القلم. ولو أن للأرواح ميزانا يقاس به ثقلها، لكان ميزان جدي، الرايس سلامانكا، راجحا بما قدم لا بما كسب. في زمن غلبت فيه غريزة الجمع، كان جدي يمارس فلسفة نادرة، هي فلسفة النقص المقدس، أن تنقص من حاجتك لتكمل نقص غيرك. لم ينظر إلى البحر كمصدر لثروة شخصية، بل كخزينة مشتركة، وكان هو أمينا عليها. لذا، فإن سيرته تتجاوز حدود مهنة الرايس لتصبح درسا في أخلاق الريادة ومبدأ العطاء غير المشروط .
في بداية الستينات، حين خنق الجوع بيوت الريف واشتد أثر مجاعة 1960 بعد أحداث 1958–1959، التي واجهها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني بحملة عسكرية واسعة، وشهدت في الذاكرة المحلية إحراقا للمحاصيل الزراعية، ومصادرة للمؤن في عدد من قرى الريف، وعلى رأسها قبيلة بني ورياغل، مما أدى إلى مجاعة قاسية مات بسببها كثيرون وأضعفت ما تبقى من موارد العيش.
في ذلك الخلاء، ظهر سلامانكا لا كصياد فحسب، بل كقوة مقاومة هادئة، رجل يفهم أن النجاة ليست فعلا فرديا، وأن الخبز والسمك يصبحان معنى أوسع حين يوزعان، لا حين يختزنان.
لقد كان جدي سلامانكا، وهو يلقي بخيره على الشاطئ، يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح أنهكها الجوع، ومن كرامة كادت تسقط بين رمال الحاجة، كأنه كان يعلن بصمته وفعله أن الإنسانية تظل ممكنة حتى في زمن يضيق بالإنسان.
إن إكرامه للناس، وتقديمه صيده للفقراء قبل وصوله إلى سوق المنافسة، ليس مجرد صدقة، بل هو إعلان فلسفي ينطوي على رؤية عميقة، فقد قدم قيمة الإنسان على قيمة السلعة، فكأنه يقول: إن شبع الجائع أولى بالرزق من قانون العرض والطلب. وكان يخصص نصيبه بالذات للنساء الأرامل، في إشارة إلى وعي اجتماعي يدرك مكامن الضعف ويسعى لتقويتها دون منة، مؤمنا بأن قوة المجتمع تقاس بحماية أضعف حلقاته. فكانت سمكته الممدودة للأرامل بمثابة تصحيح صامت لقسوة العالم، وقولا بليغا يثبت أن الريادة الحقيقية هي التي ترفع الحمل عن الأكتاف المتعبة، لا تلك التي تكثر من الأرباح.
ولعظم أثره، لم تكتف حكاية الحسيمة بنقل سيرته فحسب، بل صاغتها لحنا خالدا يتردد بشد الراء في لهجتها البقيوية
كنوع من الشهادة على كرمه، حيث يقول السكان إلى اليوم:
«ازرم قغراڤو نسلامانكا يذفد مارا ذالريم الريث مارا ذالسارذين السارسيث»
ومع أن الأسطورة تكفي لتحيي صورة الرجل، فإن الحقيقة كانت أعمق وأفصح. فلقد كان سلامانكا، كلما رست باخرته على البر، ينثر سمك البحر بين أيدي الجائعين قبل أن يحمل شيئا منه إلى السوق، كأنه يعيد ترتيب ميزان العدالة في عالم اختل ميزانه. كان يطعم الفقير قبل أن يطعم ملكه، ويجعل من رزقه جسرا بين الناس والحياة
لقد غادر سلامانكا عالمنا منذ زمن، انطوت شراعه الأخيرة، وسكن جسده سكون الأبد، ولكن فلسفته تبقى حية تتردد في صدى الأمواج. فما الذي يبقى من الإنسان بعد ارتحاله؟ ليست ثروته، بل هو نور الأثر الذي بثه في حياة الآخرين، وتلك البصمة التي حفرها في وجدان الضعفاء.
إن سيرة جدي تدعونا إلى التفكير في جوهر النجاح، أهو الاغتناء المفرط، أم هو صنع الفارق في وجود من هم أحوج؟ والجواب يكمن في صدى البحر الذي وهب رزقه لكف سلامانكا ليوزعه بالكرم لا بالحساب.
ليبق ذكر جدي سلامانكا، رايس البحار، شاهدا على عظم النفس وخلود الإيثار.
— الوعي التحرري: موقف جدي الرايس سلامانكا من تعليم المرأة :
لا تقتصر أهمية سيرة جدي الرايس سلامانكا على بعدها الاجتماعي الاقتصادي، بل تمتد إلى بعدها الثقافي والتحرري، خصوصا فيما يتعلق بموقفه من المرأة. ففي سياق اجتماعي كانت فيه الأعراف تحد من أدوار النساء، تبنى سلامانكا موقفا متقدما يؤكد حق المرأة في التعليم، والعمل، والتنقل، واتخاذ القرار.
تميز هذا الموقف بكونه ممارسة عملية لا خطابا نظريا، حيث أصر على تعليم ابنته، وتشجيعها على استكمال دراستها خارج المجال المحلي، متحديا بذلك الأعراف السائدة والنظرة المحافظة السائدة آنذاك. ويظهر هذا السلوك وعيا مبكرا بأن تحرر المجتمع مرتبط بشكل مباشر بتحرر المرأة، وأن التعليم أداة أساسية لإنتاج الكرامة والوعي.
تجسد هذا المشروع التحرري في شخصية ابنته عالية ابركان المثقفة، الواعية، التي أصبحت معلمة، لا بوصفها حاملة شهادة فقط، بل بوصفها فاعلة تربوية تحمل رسالة معرفية وإنسانية. وتمثل تجربتها نموذجا لكيفية انتقال القيم من المجال الأسري إلى الفضاء العمومي، حيث يتحول التعليم إلى فعل مقاومة ضد الجهل، وإلى وسيلة لإعادة إنتاج الوعي داخل المجتمع.
إن سيرة الرايس سلامانكا تمثل نموذجا دالا على قدرة الفعل الفردي الأخلاقي على إحداث أثر اجتماعي عميق. فقد جمع بين العطاء الاقتصادي في زمن المجاعة، والوعي التحرري في زمن القيود الاجتماعية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن الكرامة الإنسانية، ولا عن حق المرأة في المعرفة والاختيار.
وعليه، فإن تخليد مثل هذه السير لا يندرج ضمن تمجيد الأفراد بقدر ما يسهم في توثيق نماذج محلية للمقاومة الأخلاقية، ويبرز أهمية الذاكرة الاجتماعية بوصفها رافدا أساسيا لفهم تاريخ الريف المغربي وتحولاته.
** ف – الزياني