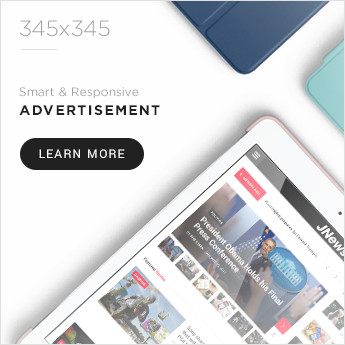إن انتخاب محمد شوكي على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن قراءته كتحول سياسي حقيقي بقدر ما يعكس استمرار منطق إعادة تدوير الوجوه داخل نفس البنية التي أدارت المشهد السياسي لعقود دون أن تُحدث أي تغيير جوهري في حياة الكادحين. ما جرى ليس انتصاراً للديمقراطية الداخلية كما يُراد تسويقه، بل إعادة ترتيب دقيقة داخل منظومة حزبية اعتادت أن تتحرك وفق إيقاع السلطة لا وفق نبض المجتمع. الأرقام التي قُدِّمت باعتبارها دليلا على الشرعية لا تعني شيئا أمام واقع سياسي يزداد فيه العزوف وتتعمق فيه هوة الثقة بين الشعب والأحزاب التي تحولت إلى مجرد أدوات تنفيذ لسياسات جاهزة. إن ما يقدم كحدث تنظيمي كبير ليس سوى مشهد آخر من مسرحية سياسية طويلة تُغيّر الوجوه بينما تحافظ على نفس الاختيارات الاقتصادية التي أنهكت الفئات الشعبية ودفعتها إلى هامش الحياة.
إن انتقال قيادة من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار يكشف بوضوح إفلاس الأحزاب الليبرالية التي فقدت أي معنى للانتماء السياسي أو المشروع الفكري. فالحدود التي كانت تفصل بين التنظيمات تحولت إلى خطوط وهمية يمكن عبورها في أي لحظة، لأن جوهر هذه الأحزاب واحد: الدفاع عن نفس السياسات النيوليبرالية التي حولت الاقتصاد إلى حقل مفتوح أمام لوبيات المال والنفوذ. هذه السيولة الحزبية ليست علامة على الحيوية، بل دليل على انعدام العمق السياسي، حيث لم يعد هناك فرق حقيقي بين تنظيم وآخر سوى في الشعارات والوجوه الإعلامية. وعندما يصبح الانتقال بين الأحزاب أمرا عاديا، فإن السياسة نفسها تفقد معناها وتتحول إلى مجرد لعبة مواقع داخل منظومة مغلقة تعيد إنتاج نفسها باستمرار.
أما الحديث عن المهام المنتظرة من الحزب في المرحلة المقبلة، فيكشف بوضوح أن المطلوب ليس بناء مشروع اجتماعي جديد، بل الاستمرار في لعب دور الوسيط الذي يمتص غضب الشارع دون أن يجرؤ على تغيير السياسات التي تولد هذا الغضب. فوسط موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، لم تعد السلطة تبحث عن أحزاب تقود تحولات حقيقية، بل عن واجهات سياسية قادرة على تسويق نفس القرارات بلغة أكثر ليونة. تغيير القيادة هنا يبدو أشبه بعملية تجميل سياسي تهدف إلى إخفاء آثار الفشل السابق، لا إلى مراجعة الخيارات التي عمقت الفوارق الطبقية ووسعت دائرة الفقر والهشاشة. إن المشكلة ليست في الأشخاص بل في النموذج الاقتصادي الذي يُفرض على المجتمع، نموذج يقدّم أرباح الرأسمال الكبير على حساب الحق في الشغل والصحة والتعليم.
اختيار محمد شوكي بدل قيادات راكمت سنوات طويلة داخل الحزب يكشف أن معيار الولاء للمرحلة أصبح أهم من معيار التجربة السياسية. فالوجوه التي تحمل ذاكرة داخلية قد تُربك عملية إعادة الضبط، بينما يتيح الوافد الجديد إمكانية تشكيل الحزب وفق رؤية فوقية تُحكم السيطرة على إيقاعه. هنا يظهر بوضوح تحوّل الأحزاب الليبرالية إلى ما يشبه أجهزة تدبير تقني، حيث يُقدَّم القادة كمديرين للمراحل لا كصناع لمشاريع سياسية. إنها تكنوقراطية حزبية تُفرغ العمل السياسي من معناه وتحوله إلى وظيفة إدارية خالية من الصراع الفكري. وهكذا يصبح الحزب مجرد آلة تنظيمية تضمن الاستمرارية وتمنح غطاءً سياسيا لقرارات تتخذ خارج فضائه، بينما يُقصى أي نقاش حقيقي حول البدائل الاجتماعية أو العدالة الاقتصادية.
السياق الذي يأتي فيه هذا التغيير يكشف أيضاً محاولة مكشوفة لإعادة تلميع صورة حزب ارتبط اسمه بسياسات أثقلت كاهل المواطنين. فبعد موجات الانتقاد الواسعة، بدا واضحا أن الحاجة إلى وجه جديد ليست سوى محاولة لخلق مسافة رمزية مع مرحلة سابقة دون المساس بجوهرها. لكن الرهان على تغيير الأشخاص لن ينجح في إخفاء حقيقة أن الأزمة أعمق بكثير من مجرد خلل في القيادة؛ إنها أزمة نموذج سياسي واقتصادي يقوم على إقصاء الفئات الشعبية من القرار العمومي. كل خطاب عن التجديد يظل فارغاً ما دام لا يطرح سؤال العدالة الاجتماعية بجرأة ولا يضع حداً لهيمنة المصالح الاقتصادية الضيقة التي تفرض إيقاعها على السياسات العمومية.
إن ما يجري داخل الأحزاب الإدارية يعري حدود التعددية السياسية التي يتم الترويج لها باعتبارها دليلاً على الديمقراطية. فحين تتشابه البرامج إلى حد التطابق، يصبح التنافس مجرد صراع على المواقع لا على الأفكار. وهذا ما يفسر الشعور العام بأن المشهد الحزبي يعيش حالة جمود عميق، حيث تتكرر نفس الوجوه والخطابات دون أن يظهر أفق سياسي جديد. إعادة تدوير القيادات لا تصنع تحولاً، بل تؤكد أن المنظومة عاجزة عن إنتاج بدائل حقيقية. إن الأزمة الحقيقية ليست في من يقود الحزب، بل في طبيعة الأحزاب التي تحولت إلى أدوات لضبط المجتمع بدل أن تكون فضاءات للنضال من أجل التغيير.
يبدو في الختام، انتخاب محمد شوكي حلقة أخرى في مسلسل طويل من إعادة هندسة الواجهة السياسية دون المساس بجوهر الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الاجتماعي. قد يتمكن الرجل من إعادة ترتيب البيت الداخلي أو تحسين الصورة الإعلامية، لكن ذلك لن يغير من واقع السياسات التي عمقت الاحتقان ووسعت الفجوة بين السلطة والمجتمع. التاريخ القريب يثبت أن تغيير الوجوه دون تغيير النهج ليس سوى محاولة لشراء الوقت، بينما يستمر نفس النموذج في إنتاج أزماته. وما لم يتم كسر هذا المنطق وإعادة الاعتبار لسياسة تنحاز بوضوح إلى العمال والكادحين، فإن كل هذه التحركات ستبقى مجرد حلقات في مسلسل إعادة إنتاج الأزمة نفسها بوجوه مختلفة وخطاب أكثر نعومة، لكن بجوهر أكثر قسوة على المجتمع.
أبو علي بلمزيان