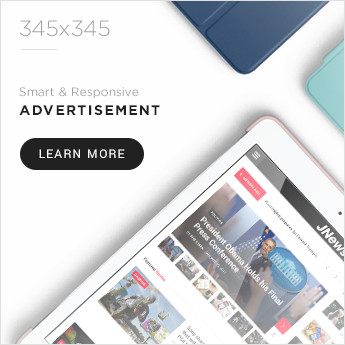لم تكن الحسيمة مجرد مدينة على الساحل المتوسطي، ولا مجرد خليج فتان يستلقي على كتف الجغرافيا المغربية، بل كانت وعدًا جماليًا وتاريخيًا، وإمكانية حضارية لصياغة نموذج متوازن بين التنمية والكرامة، بين السياحة والثقافة، بين الحلم الجماعي والذاكرة الجريحة. غير أن هذا الوعد الجميل سرعان ما تم اغتياله على يد زمرة من المنتخبين والانتهازيين الذين أعادوا إنتاج أبشع مظاهر التردي الأخلاقي والسياسي في الفضاء المحلي، باسم الديمقراطية التمثيلية، بينما هم في الجوهر مجرد أدوات وظيفية، مستأجرة لحماية مصالح أوليغارشيا المال والنفوذ التي استباحت المدينة كما تُستباح الغنيمة في حضرة القتلة.
هؤلاء ليسوا غرباء عن الحسيمة، لكنهم غرباء عن روحها، عن عمقها الشعبي، عن بؤسها النبيل الذي أفرز أجيالًا من الكفاح لا تنحني. إنهم أبناء طبقات رثة لم تنتجهم سيرورات الوعي ولا معمودية النضال، بل قذفتهم هامشية الفقر إلى حضن منظومة تحكم لا ترى في الإنسان سوى رقم انتخابي يُشترى ويُباع. وجدوا في ريع الانتخابات وتواطؤ مراكز القرار السياسي فرصتهم لسرقة ما تبقى من أمل في هذه المدينة، وصعدوا إلى منصة الحكم المحلي حفاة من كل وازع، يلهثون وراء فتات المناصب وتكديس الثروات على أنقاض معاناة الجماهير.
وفي خضم هذا التحالف الدنيء بين الانتهازية المحلية وبنية التحكم المركزية، تم تخريب المجال العمراني، وتم اغتيال الإمكانيات الثقافية، وتحولت الحسيمة إلى كائن مشوه، متضخم بالمظاهر، فقير في المعنى، رتيب في الروح. مدينة بلا رؤية، بلا أفق، بلا مشروع جماعي يعيد الاعتبار لتاريخها المقاوم، ومكانتها الرمزية كمنطقة طالما شكلت صداعًا في رأس الاستبداد.
لقد شكل هؤلاء نموذجًا فاقعًا في الفساد البنيوي، ليس فقط لأنهم دمروا البيئة الطبيعية واستغلوا المجال العام لأطماعهم العقارية، بل لأنهم أيضًا طمسوا معالم الثقافة الحقيقية، وحولوها إلى كرنفالات مدفوعة الأجر، تحتفل بالتفاهة وتُقصي كل صوت حر. كيف لمدينة أنجبت المئات من الكفاءات أن تصبح حقلًا مغلقًا على الدخلاء وعديمي الضمير، الذين لم يُعرف عنهم سوى التزلف للسلطة، والارتماء في حضن من يوزع الغنائم ويعيد توزيع البؤس؟
تاريخهم القريب يصرخ بالدلائل: باعوا المدينة مرتين، أولًا حين خانوا أمانة التمثيل الشعبي، وثانيًا حين فروا كالجرذان يوم اشتد أوار الحراك. اختبؤوا في جحورهم، وانتظروا حتى مرت العاصفة، ثم عادوا يتصدرون المشهد بلا خجل، كأن القمع لم يسحق الرفاق، وكأن المطالب لم تكن يومًا حقًا مسروقًا. وقاحة سياسية لا تُصدق، وتهافت أخلاقي لا يضاهيه سوى نفاقهم اليومي وهم يتحدثون عن الديمقراطية، وهم صنيعة الرداءة وعنوان من عناوينها.
بعضهم صار يتنكر في هيئة المثقف، يكتب بلغة ممولة من أقذر المؤسسات، يتحدث عن التنمية والنهوض، بينما هو أول من يفرغ الكلمات من معانيها ويعيد تدوير الخطاب في خدمة المنظومة. هؤلاء لا يستحقون سوى الازدراء، لا لأنهم فشلوا، بل لأنهم تعمدوا الفشل، وأداروا ظهورهم للمدينة ولأهلها، وباعوا الرصيد الرمزي الذي كان بالإمكان تحويله إلى مستقبل مشرق لأبناء وبنات الحسيمة.
ما يجري ليس حالة منفصلة، إنه جزء من منظومة كاملة من التبعية والنهب والتواطؤ. مشروع كامل تم تصميمه ليفشل، ويُعاد تدويره بأسماء جديدة، بنفس الوصفات، بنفس الفساد، بنفس الروح الانتهازية التي لا تؤمن بشيء سوى تراكم رأس المال على حساب المعنى والحق والكرامة. حين تتحول السياسة إلى مجرد حرفة مربحة، ويفقد الفعل العمومي مضمونه التحرري، تصبح المدينة ضحية يومية للمضاربات، وتُختزل في رقم حسابي في دفتر أرباح المنتفعين.
والأدهى أن هذه الكائنات السياسية تعود في كل دورة انتخابية بوجوه مغسولة بصفاقة لا توصف، تستعرض عضلاتها الدعائية، وتتحدث عن المستقبل، وهي لم تترك خلفها إلا الخراب. ما هذا الشعب الذي يُطلب منه أن يبتلع الهزيمة بصمت؟ ألا يحق للناس أن يسألوا من يحكمهم، وكيف ولماذا؟ ألا يحق لهم أن يتمردوا على إعادة إنتاج الرداءة باسم الشرعية الشكلية؟
التاريخ لا يرحم. قد لا يُذكر هؤلاء بأسمائهم، ولكن سيرتهم ستظل عالقة في الذاكرة الجماعية كرموز للخيانة والتفريط، كنماذج للارتماء الكامل في أحضان السلطة، كعلامات على تفسخ السياسة وتحولها إلى سوق نخاسة. ولكن ما زال في المدينة رمق. ما زال فيها ما يستحق الحياة. ستنهض الحسيمة ذات صباح، حين ينفض الجيل الجديد عن نفسه غبار الهزائم الموروثة، وحين يُستعاد الوعي كفعل مقاوم، لا كترف فكري.
ليخجلوا، إن بقي فيهم شيء من الحياء، وليغادروا، قبل أن تلفظهم المدينة كما يُلفظ الورم الخبيث بعد الجراحة. الحسيمة لن تموت، فهي لم تُخلق لتُستعمل، بل لتُحَب وتُبنى وتُحرر. هؤلاء قد يغتالون الحلم مرات، لكنهم لن يمنعوا انبثاقه مجددًا، من الرماد، من الشارع، من صرخة طفل يعرف أن المدينة ليست للبيع، وأن الجمال لا يُستعار، بل يُنتزع من براثن القبح بالحق والنار.
– أبوعلي بلمزيان.