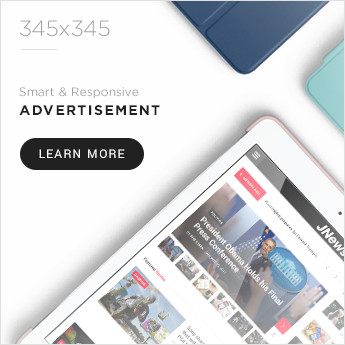إن ما حدث في شفشاون والحسيمة وتاونات يطرح سؤالا سياسيا عميقا حول منطق الدولة في تدبير الكوارث الطبيعية، لأن الامتناع عن إعلان هذه الأقاليم مناطق منكوبة رغم حجم التساقطات والانهيارات لا يمكن تفسيره فقط بمعايير تقنية أو إدارية. نحن أمام انتقائية فجة تكشف كيف تتحول الجغرافيا الهامشية إلى ضحية لصمت رسمي ممنهج، بينما تمنح صفة “المنكوب” لمناطق أخرى ترتبط بحسابات اقتصادية وسياسية أكثر وضوحا. إن خطاب الدولة الذي يدعي الحياد التقني يسقط بمجرد مقارنة المعطيات الميدانية، حيث شهدت هذه المناطق انهيار طرق وعزلة دواوير وتضرر مساكن، ومع ذلك بقيت خارج دائرة الاعتراف الرسمي، وكأن معاناة سكان الجبال أقل قيمة من خسائر الفلاحة في السهول. هذا السلوك يعكس رؤية مركزية تعتبر الأطراف مجرد خزانات طبيعية للمياه والموارد، لا فضاءات للحقوق الاجتماعية المتساوية.
من منظور تحليلي، فإن ما يجري ليس مجرد خلل إداري بل نتيجة منطق اقتصادي طبقي واضح. فالدولة في المغرب لا تتحرك إلا عندما تصبح الخسارة مرتبطة برأسمال فلاحي أو صناعي كبير، وهو ما يفسر سرعة إعلان مناطق من سهول الغرب منكوبة، لأنها تمثل قطبا إنتاجيا يهم مصالح فئات نافذة. أما المناطق الجبلية التي تمد البلاد بالمياه والثروات البيئية، فتترك لمصيرها لأن سكانها لا يملكون وزنا اقتصاديا في معادلة القرار. هذا ليس فقط تمييزا مجاليا، بل تجسيد لفلسفة تنموية ترى في الجبل عبئا لا شريكا، وفي سكانه مجرد أرقام انتخابية تستدعى وقت الحاجة وتنسى حين تتطلب الظروف إنصافا ماديا حقيقيا.
إنّ المفارقة الصادمة تكمن في أن المياه التي أغرقت السهول جاءت أساسا من المرتفعات التي تحتضن منابع الأودية المغذية لـسدي الوحدة ووادي المخازن، ومع ذلك جرى الاعتراف بالنتائج دون الاعتراف بالأسباب الجغرافية والاجتماعية التي صنعتها. هنا يظهر التناقض الصارخ في منطق الدولة: فهي تستثمر في السدود الكبرى لحماية الاقتصاد الوطني، لكنها لا تستثمر في حماية المجتمعات التي تحمل عبء هذا الخيار الاستراتيجي. هذه الازدواجية تجعل من سكان المناطق الجبلية حراسا صامتين لمنظومة مائية وطنية دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من التعويضات أو البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث. إنّ تجاهل إعلانهم منكوبين هو رسالة سياسية مفادها أن القيمة تقاس بمدى قربك من مركز القرار لا بمدى حجم الضرر الذي تتعرض له.
الخطير في هذا الانتقاء أنه يعمق الشعور بالحيف التاريخي ويعيد إنتاج هوة الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي. فحين يرى المواطن أن الإعلام الرسمي يتحدث يوميا عن أضرار مناطق بعينها بينما تمحى معاناة مناطق أخرى من السردية الوطنية، فإن ذلك يخلق وعيا جماعيا بأن الدولة ليست حكما محايدا بل طرفا منحازا. هذا الوعي لا ينشأ من الخطابات المعارضة فقط، بل من التجربة اليومية للساكنة التي تجد نفسها وحيدة أمام السيول والانهيارات. إن صمت المؤسسات عن إعلان هذه الأقاليم منكوبة يساوي، في نظر كثيرين، إعلانا ضمنيا بأن حياتهم أقل أولوية، وهو أخطر ما يمكن أن تنتجه السياسات العمومية حين تفقد بعدها الأخلاقي وتتحول إلى إدارة باردة للأرقام.
كما يكشف هذا الوضع عن أزمة حقيقية في نموذج الحكامة الترابية، حيث تظل القرارات الكبرى مركزية إلى درجة تفقد معها الجهات قدرتها على الدفاع عن مصالحها. فلو كانت هناك لا مركزية فعلية، لكان بإمكان المنتخبين والهيئات المحلية فرض الاعتراف بالكارثة بناء على معطيات ميدانية دقيقة. لكن الواقع يظهر أن القرار النهائي يظل رهين حسابات فوقية، توازن بين الكلفة المالية والتداعيات السياسية والإعلامية. وهنا يتجلى جوهر النقد اليساري الراديكالي الذي يرى في الدولة جهازا لإعادة إنتاج التفاوتات، لا أداة لتقليصها. إنّ الفيضانات لم تكشف فقط هشاشة البنية التحتية، بل هشاشة فلسفة العدالة المجالية نفسها.
إن استمرار هذا النهج يهدد بتحويل الكوارث الطبيعية إلى أزمات اجتماعية مزمنة، لأنّ غياب الاعتراف الرسمي يمنع وصول التعويضات والبرامج الاستثنائية لإعادة الإعمار. وحين تترك القرى المعزولة تواجه مصيرها، فإن الهجرة القسرية تصبح خيارا شبه وحيد، ما يؤدي إلى تفريغ المناطق الجبلية من سكانها وتسريع انهيار توازنها البيئي. هذا السيناريو ليس مجرد احتمال نظري، بل مسار يتكرر كلما جرى التعامل مع الكوارث بمنطق انتقائي. إن الدولة التي تدعي بناء نموذج تنموي جديد مطالبة بأن تعترف أولا بأن العدالة ليست شعارا بل قرارا ملموسا يبدأ بالاعتراف بالمأساة قبل معالجتها.
لا يمكن قراءة ما حدث، كخلاصة عامة، إلا كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات التي تضع المركز فوق الهامش، والاقتصاد فوق الإنسان. إن خطاب النهج الديمقراطي العمالي يذهب بعيدا حين يعتبر أن الكارثة الحقيقية ليست فيضانات الطبيعة بل فيضانات التمييز المجالي التي تمارسها الدولة. فحين يختزل المواطن في قيمة إنتاجية أو انتخابية، يصبح إعلان “الإقليم المنكوب” امتيازا سياسيا لا حقا اجتماعيا. لذلك فإن المطلوب ليس فقط مراجعة قرار إداري، بل إعادة التفكير جذريا في علاقة الدولة بالمجال الجبلي، لأن استمرار هذا المنطق لن يؤدي إلا إلى تعميق الغضب الاجتماعي وتوسيع الفجوة بين خطاب التنمية وواقع الإقصاء.
– أبوعلي بلمزيان.