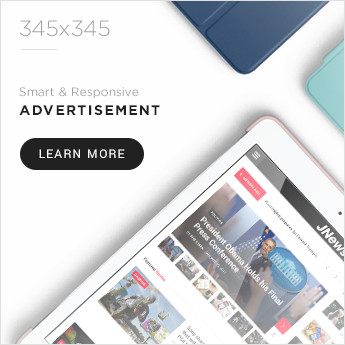لم يعد “الذهب الأخضر” يلمع كما كان في مناطق زراعة الكيف. فقد أفل زمن كانت فيه هذه الزراعة، رغم طابعها غير المنظم وهيمنة شبكات التسويق، تشكل صمام أمان اقتصادي لآلاف الأسر القروية. كان الفلاح الصغير، خصوصاً خلال سنوات الكيف البلدي، قادراً على ضمان حد أدنى من الدخل، بفضل تكاليف إنتاج محدودة، وبذور محلية محفوظة، ودورة زراعية أقل شراسة على التربة والماء.
اليوم، تقف هذه المناطق على حافة انهيار اقتصادي واجتماعي صامت، نتيجة تداخل عوامل بنيوية وسياسات عمومية مرتبكة، جعلت الفلاح الحلقة الأضعف في معادلة لم يعد يتحكم في أي من مفاصلها.
من الكيف البلدي إلى الكيف المهجَّن: انقلاب في بنية الإنتاج
شكّل إدخال الكيف المهجَّن المستورد نقطة التحول الأخطر في تاريخ هذه الزراعة. فبدعوى رفع المردودية وتحسين الجودة، فُرض نموذج إنتاج كثيف، يتطلب كميات ضخمة من مياه السقي، وأسمدة كيماوية باهظة الثمن، ورعاية تقنية لا يملكها الفلاح الصغير.
هذا التحول تزامن مع توالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى استنزاف الفرشات المائية ورفع كلفة الضخ، في مناطق تعاني أصلاً من هشاشة بيئية مزمنة. وتشير معطيات متداولة محلياً إلى أن كلفة الهكتار الواحد تضاعفت خلال العقد الأخير، في حين لم ترتفع مداخيل الفلاحين بنفس الوتيرة، بل تراجعت في كثير من الحالات.
البذور: من مورد ذاتي إلى أداة تحكم
من أبرز مظاهر هذا التحول فقدان الفلاح لسيادته على البذور. بعد أن كان يحتفظ بـ”الزريعة” من محصوله السابق، أصبح اليوم مجبراً على اقتنائها من السوق، بأسعار قد تتراوح
ما بين 5 و10 دراهم للحبة الواحدة،
ومابين 10 و15دراهم للشتلات
وهو رقم ثقيل إذا ما قورن بعدد الشتلات المطلوبة للهكتار الواحد.
هكذا تحولت البذور إلى حلقة مركزية في سلسلة الإنتاج، تتحكم فيها فئة محدودة من التجار الكبار، ما عمّق منطق الاحتكار، وربط الفلاح الصغير بدوامة مديونية موسمية لا فكاك منها.
تشديد المراقبة… دون بدائل
على مستوى التسويق، شددت الدولة الرقابة على المسالك التقليدية، في إطار محاربة الاتجار غير المشروع. غير أن هذا التشديد لم يُواكب بفتح قنوات تسويق قانونية واضحة وميسّرة للفلاحين، ولا بضمان أسعار دنيا تحميهم من تقلبات السوق.
النتيجة كانت اختناقاً اقتصادياً مزدوجاً: إنتاج مكلف من جهة، وتسويق محفوف بالمخاطر من جهة ثانية، في مقابل استمرار استفادة الوسطاء الكبار القادرين على تجاوز القيود، وامتصاص الخسائر، والتحكم في الأسعار.
التقنين: من وعد تنموي إلى عبء إضافي
قُدّم مشروع تقنين زراعة الكيف باعتباره منعطفاً تاريخياً، يهدف إلى إخراج هذه الزراعة من اقتصاد الظل، وتحسين دخل الفلاحين، وإدماج المناطق المعنية في دينامية تنموية جديدة. غير أن الواقع الميداني يكشف أن الحصيلة لا تزال دون التطلعات بكثير.
فإجراءات الترخيص المعقدة، ومتطلبات الانخراط في التعاونيات، وغياب مواكبة تقنية ومالية حقيقية، جعلت الاستفادة الفعلية محصورة في دائرة ضيقة. ووفق تقديرات فاعلين محليين، فإن النتائج المحققة إلى اليوم لا تتجاوز 5% من الأهداف المعلنة، بل إن كلفة الالتزام بالمساطر القانونية رفعت من أعباء الإنتاج، دون ضمان سوق مستقرة أو سعر عادل.
هشاشة اجتماعية وهجرة صامتة:
انعكست هذه الأزمة مباشرة على الواقع الاجتماعي. البطالة في صفوف الشباب في ارتفاع، والفقر يتعمق في دواوير تعتمد بشكل شبه كلي على هذه الزراعة. ومع ندرة مياه الشرب والاستعمال المنزلي، تحولت البيئة نفسها إلى عامل طرد.
هكذا نشطت موجات الهجرة، نحو المدن أو خارج البلاد، هجرة اضطرارية تفرغ القرى من قواها الحية، وتترك وراءها مجالات قروية مستنزفة، تعيش على هامش السياسات العمومية
إن ما تعيشه مناطق زراعة الكيف اليوم ليس قدراً طبيعياً، بل نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية. فهل أُريد للتقنين أن يكون رافعة تنموية للفلاح الصغير، أم مجرد إعادة ترتيب للسوق لفائدة فاعلين أقوى؟ وهل يمكن الحديث عن انتقال قانوني ناجح دون حماية المنتجين، وضمان الماء، وكبح الاحتكار؟
أسئلة سياسية بامتياز، ستظل معلّقة ما لم تُراجع المقاربة برمتها، وتُبْنَ سياسات تنطلق من واقع الأرض، لا من منطق الأرقام المجردة، وتضع الإنسان القروي في صلب أي تصور تنموي قادم.
** عبد العزيز بن صالح