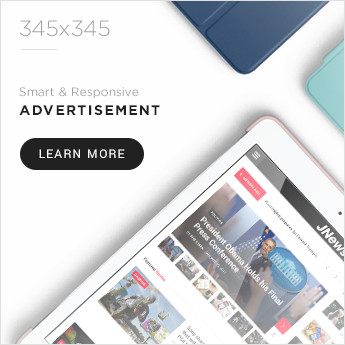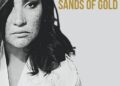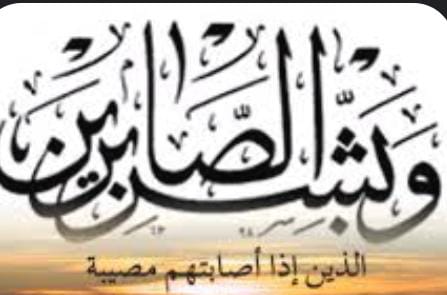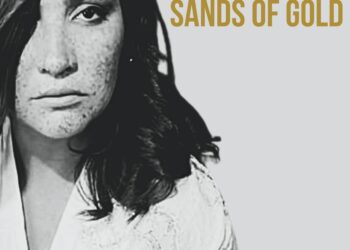ليس الغلاء الفاحش الذي يعيشه سكان الحسيمة – خصوصاً في فصل الصيف – حالة معزولة أو ظاهرة محلية محضة، بل هو امتداد طبيعي لمنطق اقتصادي تحكّمي تحكمه قوانين الاحتكار والريع وغياب المراقبة الفعلية، وتغذّيه عقلية السماسرة والمضاربين الذين يرون في الموسم الصيفي فرصة ذهبية لنهب جيوب المواطنين والزوار. غير أن ما يثير الانتباه – وربما الصدمة – هو أن بعضاً من هذا الغلاء سببه فئة من المهاجرين أنفسهم، أي أولئك الذين يرفعون أصواتهم في شكاوى ضد الغلاء، لكنهم يمارسونه بأبشع أشكاله عندما تتحول مصالحهم إلى بوصلة وحيدة للسلوك.
ليس الأمر اتهاماً اعتباطياً، بل واقع تبرزه أمثلة صارخة. في نهاية شارع طارق بن زياد قرب مصفاة تكرير المياه العادمة، نجد مقهى موسمي يفتح أبوابه في الصيف فقط، مملوك لمهاجر، يبيع فنجان القهوة ب 25 درهماً، في حين أن مقهى آخر، أكثر نظافة وجودة وملكية محلية، يقدم نفس القهوة بـ 12 درهماً. على نفس الشارع، مقهى آخر يملكه مهاجر آخر يرفع الثمن إلى 30 درهماً للفنجان. هذه ليست حالات فردية، بل نمط متكرر يمتد إلى تأجير الجيت سكي والمطاعم وبعض المرافق الترفيهية.
هنا تتجلى المفارقة الصارخة: المهاجر الذي يشتكي من الغلاء هو نفسه من يرسخ آلياته، ناسياً – أو متناسياً – أن زمن الرفاهية الأوروبية انتهى، وأن كثيرين منهم يعيشون على المساعدات الاجتماعية أو بالكاد يتدبرون معيشتهم. لكنهم يأتون إلى مسقط رأسهم ليعرضوا سيارات فاخرة غالباً ما تكون مكتراة، بهدف تغذية صورة زائفة عن البذخ، صورة تتحول إلى فخ نفسي واقتصادي للشباب المحلي الذي يتوهم أن الهجرة تعني بحراً بلا ضفاف من الثراء.
الأخطر أن هذه الفئة من المهاجرين ليست مجرد جزء من مشهد الغلاء، بل هي أداة لإعادة إنتاج القيم الرأسمالية الاستهلاكية المتوحشة في بيئة محلية كانت – قبل عقود – مبنية على التضامن والتكافل. ومع التحولات الثقافية التي رافقت موجات الهجرة، تسربت أيضاً أفكار متشددة مرتبطة بالإسلام الوهابي، نقلها بعض المهاجرين عن وعي أو بدونه، مما أسهم في تقويض البنية الروحية والاجتماعية للإسلام المغربي الشعبي المنفتح، واستبدالها بثقافة ظلامية ترفض التنوع وتكرس الانغلاق.
إذا أردنا قراءة الظاهرة من منظور اقتصادي نقدي، فإن ما يحدث في الحسيمة ليس سوى صورة مصغرة لآلية الرأسمالية الطرفية التي تدمج الاقتصاد المحلي في دورة استهلاكية موسمية، حيث يصبح المواطن المحلي – وحتى المهاجر الأقل دخلاً – رهينة للمضاربة. المهاجر هنا ليس مستثمراً منتجاً، بل وسيطاً يقتنص فرصة الموسم لتعظيم الربح بأقل جهد وأدنى التزام أخلاقي.
الأرقام الرسمية تكذب الادعاء القائل إن عدد المهاجرين في تراجع. فقد تجاوز عدد من دخلوا المغرب حتى نهاية يوليوز هذه السنة أزيد من مليونين وسبعمائة ألف، بزيادة تفوق 10% عن السنة الماضية. غير أن جزءاً كبيراً منهم لا يستقر في الحسيمة، بل يتجه إلى مدن أخرى حيث يجد خدمات أفضل وأسعاراً أكثر تناسباً مع الجودة. وهذا يعني أن المدينة تخسر حتى على مستوى الجاذبية السياحية، لأن الغلاء الفاحش لا يقترن بخدمات ذات مستوى، بل يترافق مع تردي البنية التحتية وفوضى الشواطئ ورداءة المعاملة.
إن ما يغيب عن وعي جزء من المهاجرين هو أنهم يتحولون – من حيث لا يدرون – إلى جزء من المشكلة بدل أن يكونوا رافعة للحل. فبدلاً من الاستثمار في مدينتهم وقراهم، يأتون لتصفية ممتلكات ورثوها عن آبائهم وتحويلها إلى عملة صعبة تعود معهم إلى أوروبا، في ما يشبه “الهجرة المعكوسة”. إذا كان الجيل الأول قد ضخ العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المحلي، فإن الجيل الحالي يمتص ما تبقى من الثروة العائلية لسد فجوة بطالته في المهجر. والأسوأ أن بعضهم يعيش على إعانات اجتماعية في دول الإقامة، بينما يمارس التضليل على تلك الدول ويستعرض في بلده الأم مظاهر الغنى الزائف.
هذا السلوك لا يمكن فصله عن منطق الرأسمالية المتأخرة، حيث تُستنسخ أنماط الاستغلال في كل المستويات: من الشركات العملاقة التي تحتكر الأسواق إلى الفرد العادي الذي يستنسخ عقلية الاستغلال في مقهاه أو مطعمه. المهاجر – في هذه الحالة – لا يختلف عن البرجوازي الطفيلي، سوى في حجم رأس المال. إنه يتبنى نفس القيم: تعظيم الربح في أقصر وقت، استغلال ظرفية السوق، وتغليف ذلك كله بخطاب اجتماعي يبرئ نفسه ويلقي باللوم على “الظروف” أو “الآخرين”.
لا يمكن أيضاً إغفال البعد الثقافي والسياسي للظاهرة. فالمهاجر، حين يندمج اندماجاً استلابياً في الثقافة الاستهلاكية الغربية، يفقد القدرة على قراءة واقع مدينته من منظور نقدي، بل يراها مجرد منصة لعرض صورته الاجتماعية الجديدة. وعندما يمتزج هذا السلوك مع الانجرار وراء خطاب ديني متشدد مستورد، فإن النتيجة تكون مدمرة: انهيار منظومة القيم المحلية التي كانت تحمي المجتمع من الابتذال، وتحويل العلاقات الاجتماعية إلى ساحة تنافس على المظاهر والربح السريع.
إن معالجة الغلاء في الحسيمة لا يمكن أن تقتصر على الحديث عن غياب المراقبة أو جشع التجار، بل يجب أن تمتد إلى مساءلة دور المهاجرين أنفسهم كفاعلين اقتصاديين وثقافيين. كيف يمكن لمدينة أن تطور اقتصادها المحلي إذا كان جزء من نخبتها المالية الموسمية يرفض الاستثمار الإنتاجي، ويكتفي بممارسات طفيلية لا تخلق فرص عمل ولا تحسن الخدمات؟ وكيف يمكن مواجهة الغلاء إذا كانت ثقافة الاستهلاك المظهري تزداد ترسخاً بفعل استعراضات صيفية فارغة؟
التحليل النقدي يرى أن الحل لا يكمن في الرهان على “حسن النية” أو الوعي الفردي، بل في تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح لمثل هذا الغلاء بأن يصبح قاعدة. وهذا يعني فرض قوانين صارمة على الأسعار والخدمات في الموسم، تشجيع التعاونيات المحلية، محاربة الاحتكار، وتطوير اقتصاد إنتاجي بديل يقطع مع منطق المضاربة الموسمية. كما يعني إعادة الاعتبار للقيم التضامنية التي كانت جوهر الحياة في الريف قبل أن تغزوها ثقافة السوق المتوحش.
في النهاية، الغلاء في الحسيمة ليس مجرد ارتفاع في الأسعار، بل هو انعكاس لصراع بين نموذجين: نموذج تضامني تعاوني كان يحكم الحياة المحلية لعقود، ونموذج رأسمالي استهلاكي استيطاني يتسلل عبر المهاجرين والوسطاء والسماسرة. وكما كان الاستعمار القديم يعتمد على النخب المحلية لتكريس هيمنته، فإن الرأسمالية المعاصرة تجد في بعض المهاجرين أفضل وكلائها لإعادة إنتاج نفس آليات الاستغلال، ولكن هذه المرة تحت غطاء الانتماء إلى “أرض الأجداد”.
إن مواجهة هذا الواقع تبدأ بكشفه بلا مجاملة، وبإدراك أن المهاجر ليس دائماً الضحية، بل يمكن أن يكون أيضاً جزءاً من ماكينة الاستغلال التي تطحن الفقراء في موسم الصيف، وتترك المدينة في بقية السنة تواجه وحدها خراب السوق وتآكل القيم. هكذا فقط يمكن للحسيمة أن تتحرر من الغلاء الفاحش، وتعيد وصل ما انقطع بين أبنائها في الداخل والخارج، على أساس المساواة والتضامن والإنتاج لا على أساس الاستهلاك والاستعراض.
ابو علي بلمزيان