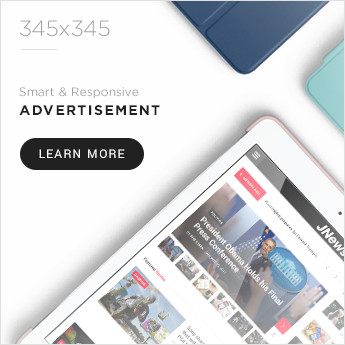في أقصى شمال المغرب، بين جبال الريف المنيعة، ترقد بلدة تماسينت حيت رأيت النور، وحيث تربيت بين شعابها، ترقد كجمرة خامدة فوق جرح مفتوح. بلدة يعود تاريخها إلى ما قبل نشأة مدن كبرى في الاقليم، كالحسيمة وامزورن، لكنها اليوم تقبع في زاوية الإهمال، تدفع ثمن وفائها لذاكرة المقاومة، وولائها لنبض الحرية.
تماسينت ليست قرية منسية، بل مقصودة بالنسيان. ليست مهمشة، بل مستهدفة بالتهميش. لكنها، رغم كل ذلك، لم تتخل عن كبريائها. ما زالت واقفة، بجراحها، ترد على الخراب بالتحدي، وعلى الإقصاء بالمعنى. ما زالت تلد الرفض، وتربي على الوعي، وتحرس جذوة الحرية من الانطفاء.
تماسينت ليست مجرد تجمع سكني مهمش. إنها بلدة ذات حمولة تاريخية ثقيلة، ارتبط اسمها بمحطات مفصلية في تاريخ الريف والمغرب عامة. ففي سنوات المقاومة ضد الاستعمار، كانت قاعدة خلفية للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، يلجأ إليها حين تشتد عليه المحن، ويجد في هدوئها فسحة للتأمل وإعادة رسم معالم المعركة.
وليس اعتباطا، عندما مرّ الرحالة والمفكر اللبناني أمين الريحاني على شمال المغرب في مطلع القرن العشرين، أطلق على تماسينت لقب “سيدة القرى”، تعبيرا عن هيبتها، وجمالها، ومركزها الريفي المتقدم.
وفي انتفاضة الريف الكبرى 1958/1959، كانت تماسينت من أولى البلدات التي خرجت تطالب بالكرامة، فتلقت نصيبها من القمع، لكنها لم تتراجع. وبعد زلزال الحسيمة سنة 2004، رفضت تماسينت أن تنخرط في إعادة الإعمار بالشروط الرسمية، وفضلت الحفاظ على كرامتها بدل الاستسلام للمنطق الإحساني للدولة. وفي حراك الريف ظلت قابضة على الجمر الى اخر نبض في العروق.
ورغم كل هذا التاريخ، فإن تماسينت اليوم لا تزال أسيرة مشكلات بدائية: غياب الصرف الصحي، رداءة البنية التحتية، وافتقارها إلى طرق معبّدة تربطها بدواويرها المجاورة. وكأنها تعاقب لانها لم تخضع، ولأنها ظلت حارسة لضمير الريف والحرية، تُذكّر باستمرار السلطة المركزية بأن هناك في هذه الارض من لم يوقع على نهاية الحكاية.
في مغرب اليوم، حيث تمنح التنمية وفق منطق الولاء، وتوزع الامتيازات على من يصفق، تبقى تماسينت شوكة في حلق هذا النظام، بلدة تتقن فن البقاء رغم كل أشكال الحصار. إنها، ببساطة، بلدة لا تنحني.
محمد الموساوي