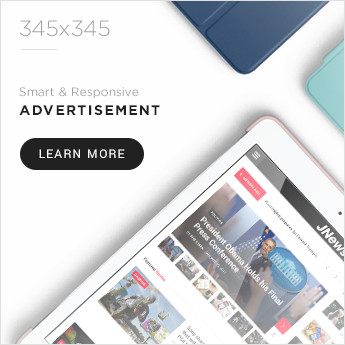لم يكن استبعاد أقاليم الحسيمة وتاونات وتازة وشفشاون ووزان من لائحة المناطق المنكوبة مجرد خطأ إداري عابر، بل كان فعلا سياسيا فجا يفضح منطق الدولة حين تواجه الهامش: الإنكار أولا، ثم التبرير. ما جرى ليس زلة تقنية، بل ممارسة سلطوية مكتملة الأركان، حيث تتحول التقارير إلى أدوات لتبييض الواقع، وتصبح الإدارة جهازا لإعادة إنتاج الكذب الرسمي. حين تصرخ الأرض تحت وطأة الفيضانات، وتنهار الطرق، ويقطع الكهرباء، وتغرق الحقول، ثم تأتي التقارير لتقول إن “الوضع تحت السيطرة”، فنحن لا نكون أمام اختلاف في التقدير، بل أمام جريمة سياسية ضد الحقيقة. إنها لحظة تتعرى فيها البيروقراطية كجهاز أيديولوجي، لا ينقل الواقع بل يعيد صياغته بما يخدم مركز القرار ويريح ضميره البارد.
لقد شهدت هذه الأقاليم تساقطات استثنائية بكل المقاييس، لكن الدولة اختارت أن تتعامل معها بعينين مغمضتين. البنيات التحتية الهشة التي تركتها سنوات من الإهمال النيوليبرالي انهارت بسرعة، لأن منطق التدبير العمومي القائم على التقشف والانتقائية لا يبني دولا، بل يصنع كوارث مؤجلة. الطرق التي لم تصنف يوما ضمن أولويات الاستثمار تحولت إلى مصائد طينية، والقناطر التي بنيت بمنطق الحد الأدنى جرفتها السيول بسهولة. ومع ذلك، بدل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها التاريخية في تعرية هذه المناطق، لجأت إلى حيلة مألوفة: تصغير الكارثة في التقارير حتى لا تكبر في السياسة. هكذا تتحول الأرقام إلى أدوات تضليل، لا إلى مؤشرات إنقاذ.
لكن الواقع كان أبلغ من كل بلاغ رسمي. مئات الدواوير عاشت عزلة قسرية، لا ليوم أو يومين، بل لأسابيع من الانقطاع الكامل. الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية سقطت تباعا، والمسالك الجماعية اختفت تحت الوحل، فصار الوصول إلى المستشفى مغامرة، وإلى المدرسة مستحيلا، وإلى السوق حلما مؤجلا. هنا تتجلى الطبيعة الطبقية للكوارث: المدن تنقذ بسرعة لأنها مرئية، أما القرى فتترك لتتعفن في العزلة لأنها خارج الكاميرات. الكارثة في الهامش لا تقاس بعدد الضحايا، بل بقدرة الضحايا على الصراخ. وحين يكون الضحايا فقراء، فإن صراخهم لا يصل إلى مكاتب السلطة.
ثم جاءت الضربة القاصمة للفلاحين الصغار، أولئك الذين يعيشون أصلا على حافة الكفاف. موسم فلاحي بأكمله انهار تحت المطر: تربة انجرفت، محاصيل تعفنت، حقول تحولت إلى مستنقعات. لكن الدولة التي تتحدث كثيرا عن “السيادة الغذائية” صمتت حين ضاعت مواسم الفقراء. الأسوأ من ذلك كان نفوق القطيع، أي تحطيم آخر مدخرات العالم القروي. حين يموت القطيع، لا يموت الحيوان فقط، بل يموت الأمان الاجتماعي لعائلة بكاملها. ومع ذلك، تعاملت التقارير مع هذه الخسائر كأرقام هامشية، لأن الاقتصاد الذي لا يدخل في حسابات السوق الكبرى لا يستحق، في نظر الدولة النيوليبرالية، سوى التعاطف اللفظي.
المفارقة الأكثر فجاجة أن من ساهم في هذه الجريمة الرمزية هم أنفسهم ممثلو الدولة محليا. عمال الأقاليم ولجان اليقظة، الذين يفترض أنهم صوت الساكنة، تحولوا إلى حراس للرواية الرسمية. بدل أن ينقلوا الألم كما هو، قاموا بتعقيمه إداريا قبل رفعه إلى المركز. لقد لعبوا دور الفلتر السياسي الذي يحذف ما يحرج السلطة ويُبقي ما يُرضيها. هنا لا نتحدث عن خطأ فردي، بل عن ثقافة سلطوية راسخة: المسؤول الجيد هو من يطمئن المركز لا من ينصف الهامش. وهكذا تصبح التقارير وثائق ولاء، لا وثائق حقيقة.
أما الحديث عن “معايير تقنية” فهو مجرد ستار أيديولوجي رخيص. فالمعايير التي تطبّق بصرامة على الهامش تعلق حين يتعلق الأمر بالمراكز النافذة. لو كان الميزان عادلا، لكانت هذه الأقاليم في صدارة لائحة المناطق المنكوبة. لكن الدولة التي تدبر المجال بمنطق غير متكافئ لا يمكن أن تنتج إنصافا متكافئا. هناك مغربان: مغرب يرى ويعترف به بسرعة، ومغرب آخر يدفع إلى الظل حتى وهو يغرق. وما حدث ليس استثناء، بل حلقة جديدة في مسلسل تاريخي من التهميش الممَنهج.
النتيجة المباشرة لهذا القرار ليست فقط حرمان الساكنة من دعم آني، بل تعميق الجرح الاجتماعي. حين تستبعد منطقة من تصنيف “النكبة”، فإنها تستبعد تلقائيا من برامج الإعمار والتعويض والاستثمار. أي أن الكارثة لا تنتهي مع انحسار المياه، بل تستمر في شكل فقر مزمن وبنيات مدمرة واقتصاد محلي مختنق. هكذا تتحول التقارير الكاذبة إلى أدوات لإنتاج الفقر، لا مجرد أوراق إدارية. إننا أمام عنف بارد، لا يرى في الشوارع لكنه يمارس في المكاتب.
غير أن أخطر ما في الأمر هو الأثر الرمزي العميق. حين تقول الدولة، عمليا، إن معاناتك لا تستحق الاعتراف، فهي لا تهينك فقط، بل تجردك من حقك في أن تكون مرئيا. إنها لحظة يتكثف فيها الإقصاء في أقسى صوره: إقصاء من الجغرافيا، ثم من الاعتراف. وهذا ما يفسر تراكم الغضب الصامت في هذه المناطق، حيث لم يعد الناس يطالبون بالتنمية فقط، بل بالاعتراف بإنسانيتهم السياسية. فالدولة التي لا ترى مواطنيها وهم يغرقون، كيف تريد منهم أن يثقوا فيها وهم واقفون على اليابسة؟
من هنا، فإن إعادة فتح هذا الملف ليست ترفا خطابيا، بل ضرورة نضالية وأخلاقية. المطلوب ليس فقط تصحيح التقارير، بل فضح المنظومة التي أنتجتها. المطلوب مساءلة سياسية حقيقية، لا ترقيع إداري. لأن المسألة أعمق من خطأ تقدير؛ إنها تعبير عن نموذج تدبير قائم على احتقار الهامش وتقديس الصورة. والدولة التي تخاف من الحقيقة إلى هذا الحد، هي دولة تخاف من شعبها أكثر مما تخاف على شعبها.
تكشف هذه الفضيحة في الختام وجها مألوفا للسلطة: سلطة تقتل الحقيقة أولا، ثم تتساءل لماذا يموت الأمل. وبين أرضٍ جرفتها السيول وتقارير جرفتها الأكاذيب، يقف الناس عراة إلا من غضبهم. وهنا فقط تتضح المعادلة كما هي: ليست الكارثة في المطر، بل في النظام الذي يجعل من الكارثة فرصة إضافية لمراكمة الإقصاء. وحين تصبح التقارير أداة لدفن الحقيقة، فإن النضال من أجل الاعتراف لا يعود مطلبا إصلاحيا، بل ضرورة وجودية. هنا لا يكون السؤال: هل كانت الكارثة حقيقية؟ بل: كم من الكوارث تحتاجها هذه الدولة لتقول أخيرا الحقيقة؟
– أبوعلي بلمزيان.